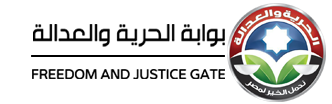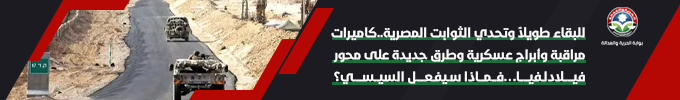يقول المفكر الفرنسي فيليب برو، في كتابه “علم الاجتماع السياسي”, إنه “إذا قامت حكومات استبدادية بتنظيم انتخاباتٍ تعتمد مبدأ المرشح الوحيد على نطاق واسع، فإنه لا يكفي تفسير هذا السلوك الثابت بمجرد حبها للتنكر. إنها تعلم، في الواقع، الفوائد السياسية التي ستجنيها منها، وهي “تقوية سلطتها من خلال إثبات قدرتها على تأمين مشاركة كثيفة، والتقليل مسبقا من قيمة مظاهرات المعارضة من خلال الحصول من الناخبين على مظاهر انتماء خارجية لها (للسلطة) وبالعكس”.
وتحدث الفيلسوف اليوناني أرسطو عن طريقتين تؤديان إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي: الأولى أن يروّع المستبد شعبه ويرهبه ويضطهد معارضيه، والأخرى أن يتّبع بعض أساليب الخداع السياسي لتجميل صورته أمام الشعب، وتصدير نفسه إليه باعتباره المستبد العادل، والترويج لأعمال عظيمة يصنعها له، لكنها لا تحدث في الواقع، أو حتى تضخيم أعمال حدثت بالفعل.
وأكد نيقولو ميكافيللي، صاحب كتاب “الأمير” الشهير، أن المستبد يستطيع أن يفعل بشعبه ما شاء شريطة أن يتبع هذه الآلية الثانية بدقة.
وهنالك أيضاً بعض الآليات الشهيرة في عالم السياسة كخلق عدو وهمي أو تضخيم الصورة الوحشية لعدو موجود بالفعل؛ بهدف توحيد الناس تحت شعار “محاربة الأعداء”.
ولكن كل هذه الآليات التي تعطينا فكرة عن كيفية إخضاع الديكتاتور لشعبه المطيع لا تعفينا من السؤال “لماذا يخضع الناس؟ ولماذا يكون بعض الناس أكثر قابلية للاستجابة لمثل هذه الآليات؟ وهل هنالك شعوب تكون أكثر استعداداً من غيرها لتقبل الديكتاتور؟
شعوب لا تعرف الثورة
يقول المفكّر جورج دبليو هالجارتين، في كتابه “لماذا الديكتاتور؟”، إن كل الشعوب من الممكن أن تمر بتجربة الحكم الديكتاتوري إذا توفرت بعض الشروط والملابسات التاريخية والاجتماعية التي تجعلها مستعدة لتقبل فكرة الحاكم المستبد والتعايش معها.
النموذج الأول من الشعوب التي خضعت للاستبداد على مدار فترات طويلة من تاريخها هو نموذج الشعوب النهرية. والجملة الشائعة في هذا الشأن هي مقولة المفكر المصري جمال حمدان: “الشعوب النهرية لا تثور”.
وكتب المفكر الألماني “ويتفوجل” كتابًا بعنوان “الاستبداد في الشرق”، وفيه يضرب بعض الأمثلة عن الشعوب التي نشأت على ضفاف الأنهر في ظل طبيعة جغرافية خاصة تجعل من النهر وحده المورد الرئيسي للحياة كمصر والصومال القديمة والصين.
ويفسّر “ويتفوجل” نظريته بقوله “إن هذه الشعوب أقامت حضاراتها على الزراعة حول مياه النهر، بالشكل الذي يجعل المطلب الأول للمزارعين هو التحكم بسير النهر وتنظيم الفيضانات العارمة وإقامة المجاري وقنوات الري.
وكانت الإمبراطوريات التي نشأت في هذه البلدان تقوم على فكرة أن يقوم الملك بالتحكم في هذه الأمور، ويضمن بذلك ولاء السواد الأعظم من الناس وهم المزارعون.
وعليه، أنشأ الحكام نظام حكم شديد المركزية وهيكلاً وظيفياً هرمياً يجلس الملك على رأسه، مع وجود جيش قوي يحكم هذا النظام ويسخِّر المزارعين لإنشاء الترع والقنوات.
ويشير “ريتشارد بهرندت”، وهو أحد فلاسفة معهد فرانكفورت في ألمانيا، إلى وجود مفاهيم خاطئة في المجتمعات الناشئة، مفادها أن الحل الوحيد لإحداث تطور سريع هو سيطرة شخص واحد على الحكم وتمكينه من تطبيق خطة نهضوية شاملة.
ويحذر في كتابه “الاسترتيجيات الاجتماعية للبلدان النامية”، من أن سيطرة هذا المفهوم، مهما كانت النتائج الإيجابية الناتجة عنه، تؤدي إلى تأخير التطور المجتمعي المتمثل في الارتقاء بوعي الجماهير وسلوكهم الحضاري. وبرأيه، هذه الأشياء لا تتطور إلا من داخل المجتمع لا بالإملاء من الخارج، كما أن هذا التأخير من شأنه أن يذهب بكل الإيجابيات المحتملة.
الجهل والديكتاتورية
ويتحدث كثيرون عن أهمية التعليم الجيد في الارتقاء بوعي الإنسان. وربما يفسّر هذا الأمر شيئاً من المشكلة في بعض البلدان التي يرتفع مستوى الجهل فيها وتتدنى جودة التعليم، ما يجعل شعوبها عرضة للتأثر السريع بأساليب الديكتاتور.
لكنَّ الجهلاء قد لا يكونون وحدهم المعرّضين للخضوع للاستبداد، حيث إن المثقف الذي يمتلك وعياً كافياً يفترض أن يؤهله لرفض الديكتاتور يمكن أن يتحوّل إلى أداة في يد النظام، لكن ما يختلف هو أنه يخضع بوعي، وهذا يجعل شعوره بالذنب أقوى. لذلك، يلجأ إلى آليات نفسية لتنحية هذا الشعور بالذنب. فقد يمنح ضميره بعض المسكنات من قبيل المعارضة السرية للسلطة، وقد يكتب بعض الكتابات سراً ويضعها في درج ليشعر بممارسته شيئاً من الحرية الذاتية.