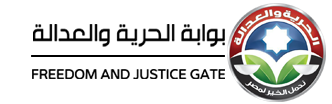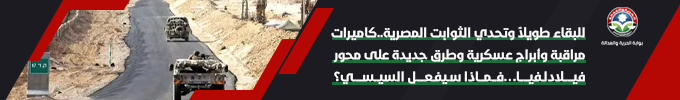توصَّلت دراسة للمعهد المصري للدراسات إلى أنه لا يوجد حل عسكري ممكن في ليبيا، وأن الطرف الذي يدعمه السيسي غير معترف به دوليا. وطوال ست سنوات من الدعم لم يستطع السيطرة على مساحة ثابتة من ليبيا، وسيطرته شكلية، ومساحة ليبيا تتجاوز 1.7 مساحة مصر، وسيطرة هذا الطرف على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة، كما هو الوضع بالنسبة للأطراف المناوئة له.
وقال الباحث عمر سمير خلف، في دراسة بعنوان “المعضلة الليبية والأمن القومي المصري: المعادلات والأولويات”: إن “معادلة الأمن القومي تقول إن لدى النظام (الانقلاب) مشكلة جوهرية في موضوع المياه، إذ يتهدد أمنه المائي والبيئي والاقتصادي والغذائي وتتهدد السيادة الغذائية المصرية، حيث ستسهم أزمة المياه في انخفاض المساحة المنزرعة، وانخفاض قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من الغذاء، فضلا عن تدهور صادراتها الزراعية وتأثيرات ذلك على الميزان التجاري، فضلا عن تأثير هذا الشح في المياه على حركة السكان وهجراتهم الداخلية والخارجية ومؤشرات البطالة والفقر، وبالتأكيد فإن أمن المياه أولوية أولى تسبق كافة الأولويات، أو هكذا يفترض أن تكون”.
مضيفًا أنه “ولذلك البعد تحديات وتهديدات إقليمية، منها: تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على مساحة نفوذهما بالمنطقة، وحساسية دول الخليج التي تملك تحالفات استراتيجية مع مصر، ما يرتب على مصر التزامات إقليمية ناحية الخليج، الداعم الأكبر للنظام السياسي المصري.
واعتبر الدراسة أن الانقلاب لا يملك رفاهية التخلي عن هذه الدول، وخياراته محدودة جدا تجاه أية اضطرابات محتملة بينها وبين إيران، والنظام تورط في الأزمة الخليجية دون داع قوي، سوى استضافة قطر لرموز المعارضة المصرية.
الصراع يضر مصر
ومن بيان أبعاد الأمن القومي، توصلت الدراسة إلى أن التدخل المصري في ليبيا بدعم أي طرف يجانبه الصواب في أكثر من ناحية، فهو يغذي صراع الشرعيات الذي بدأ منذ فبراير 2014، وكان يفترض باتفاق الصخيرات المدعوم أمميًا والتوافقات الدولية اللاحقة.
وأضاف أن ليبيا دولة جوار مباشر، وبالتالي عدم الاستقرار فيها يضر مباشرة بالأمن القومي المصري، ويجلب مزيدا من التدخلات الإقليمية والدولية، كما أن الصراع هناك ليس صراعا بين (إخوان مسلمين) أو إسلام سياسي وجيش وطني كما تتأسس الرؤية المصرية، فالإخوان وحزبهم “العدالة والبناء” كانوا الرقم الثالث في المعادلة السياسية الحزبية الليبية بانتخابات المجلس الوطني الانتقالي بعيد الثورة مباشرة، وهناك مكونات محلية وجهوية وفيدرالية قوية، ثم وجود تيار ليبرالي مدني كبير.
المكايدة مع تركيا
ونصحت الدراسة “مصر” بأن تعيد التفكير في خططها، وأن تبتعد عن أجواء المكايدات السياسية مع تركيا، وتعود لموقع الطرف الوسيط الضاغط باتجاه تسوية ما للأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات والجهود الأممية، وأن تدخل على خط التوافقات الروسية التركية الأخير، فاستقرار ليبيا يعني البدء بشكل أسرع في عملية إعادة الإعمار.
ودعت إلى أن يكون دور مصر إيجابيا في التسوية، هذا يعني نصيبا أكبر لشركات المقاولات المصرية في كعكة إعادة الإعمار.
وأوضحت أن ليبيا قبيل الثورة كانت تستوعب قرابة مليون ونصف مليون عامل، مضيفا أنها بحاجة لضعف هذا الرقم حال اتجاهها للاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني إنعاشا اقتصاديا لمصر بتحويلات أكبر من الرقم السنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما لهذه العمالة المهاجرة من أثر في تخفيض مؤشر البطالة والفقر.
الاتفاق البحري
وفي سياق متصل، توصلت الدراسة إلى أنه كان الأولى بمصر أن تعقد هي اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق، لكنها تركت المجال لأطراف تعتبرها مناوئة للذهاب بهذا الاتجاه، معتبرة أنه على الأقل فإن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لا يضر بالمصالح المصرية، بل يُضيف لمصر مساحات وحقوقًا بحرية أوسع من الترسيم المصري القبرصي اليوناني الصهيوني للحدود البحرية، فبحسب الترسيم التركي قد تقع بعض حقول الغاز الصهيونية داخل المياه الإقليمية لمصر.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في هذا الشق من الاتفاق التركي الليبي، فإن كان يعزز مساحاتها البحرية ومصالحها فلا مجال للمكابرة أمام الاعتراف به، بل ومراجعة ترسيماتنا السابقة مع إسرائيل واليونان وقبرص.
أبعاد غير أمنية
وأشارت الدراسة إلى حاجة مصر إلى نظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان الأبعاد غير الأمنية لمفهومها عن أمنها القومي، تستهدف مضاعفة مصالحها الاقتصادية في دول جوارها المباشر، وهو ما يعني تعظيم المصالح السياسية والاقتصادية، وأن تدرك أن تكلفة الحل العسكري باهظة وغير واقعية، وتخصم من رصيدها لدى الليبيين، وأن المسألة أعقد من سيطرة ظاهرية على بعض المدن، حيث تتشابك القبائلية مع المناطقية مع وجود مجالس بلدية ومجموعات مسلحة تقوم بأدوار الجيش والشرطة الغائبين، ولديها شرعيات في مدنها، وأن هذا الطرف الذي تدعمه لن يستطيع الحسم ولا حماية وضمان أية مصالح مصرية؛ لأن سيطرته على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة كما هو الوضع بالنسبة لخصومه.
واعتبرت الدراسة أن الكثير من المسئولين والباحثين المصريين يرتكبون مغالطات كثيرة في رؤيتهم للثورات السورية واليمنية والليبية، ترتبط هذه المغالطة في محاولة اجترار الواقع المصري وأدوات تحليله وتطوراته أو انتكاساته على وقائع قلما تتشابه مع السياق المصري، لا من حيث بنية الدولة ولا تطورها، ولا التركيبات القبلية والاجتماعية حتى، فيتم تحليل اللحظة الراهنة وكأنها وليدة الصدفة.
واستدركت أنه “يندر أن تجد دراسات مصرية معمقة للوضع الليبي قبيل 2014، ولكن تجد سيلا من التحليلات السطحية لما يسمونه الحرب الأهلية الليبية تارة، وحرب “الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب أو المليشيات المسلحة” تارة أخرى، وصولا لرؤية التدخل والدعم العسكري لحفتر باعتباره “الدفاع عن الأمن القومي المصري في ليبيا”، بينما هذا الأمن القومي ينكمش تماما عند ذكر التهديد الإثيوبي لماء المصريين أو الاستيلاء الإسرائيلي على غازهم وتصديره لهم عبر شركات وسيطة تابعة لجهات سيادية مصرية، في استعادة تامة لإرث فساد نظام مبارك في ملف الغاز.
الرؤية مأزومة
ورأت الدراسة أن تحليلات باحثي الانقلاب تتلبّس الرؤية الرسمية تجاه الثورات العربية باعتبارها مؤامرة كونية على دول عربية، لا يزال زعماء أكبرها يصفونها بأشباه الدول بعد ادعائهم بإنقاذها من الفوضى والسقوط، ومن ناحية ثانية تستكثر هذه الرؤية على الليبيين أو السوريين أو اليمنيين الحق في الثورة والتحرر والمطالبة بالعيش الكريم والحرية والكرامة الإنسانية أسوة بالمصريين أو التونسيين، وكأن المركزية المصرية تحتكر الثورة أو باعتبارهم أرقى عرقا وأنقى سلالة منهم.
وأوضح أن نتائج هذه الرؤية التي نضجت بعد موجة الثورات المضادة في 2014، وتدهور الأوضاع في مصر، واستفحال أزمة الإرهاب في العراق وسوريا بظهور وانتشار تنظيم داعش، ثم التدخلات والتحالفات الدولية لمحاربته، حيث خفتت لافتة الثورات العربية لصالح لافتة النظم التي رفعت وعنوانها الرئيسي الحرب على الإرهاب، والمؤامرات الكونية على الدول العربية، وارتباطها بتفسيرات سطحية للتاريخ وحركة البشر الحالية، ضمن عمليات اتهاميّة متبادلة بين أنساق فكرية مختلفة، تُوظَّف تعبويًّا للتراشق بين تيارات قومية ووطنية ودينية مأزومة، والمؤامرة بهذا المعني تملك حجية سحرية في الوصف والتفسير للتاريخ، بل وحتى للحاضر ممثلا بالثورات العربية.