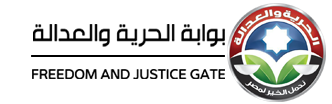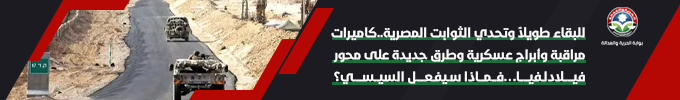نشر المركز العربي في واشنطن تقريرا سلط خلاله الضوء على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر بعد مرور 7 عقود على ثورة 23 يوليو، وتداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل عبدالفتاح السيسي في الحكم.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة"، فبعد مرور واحد وسبعين عاما على ثورة 23 يوليو 1952، التي نظمتها حركة الضباط الأحرار، تهدد الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بتفكيك قشرة الاستقرار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال التقرير إن نظام السيسي يواصل السعي للحصول على تمويل لمشاريعه الضخمة وتجنب التنفيذ الكامل للإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يطالب بها المقرضون. وتعمل حكومة السيسي في ظل ظروف العجز في الموازنة، وارتفاع الدين الوطني والطلب على خدمة الدين، وارتفاع التضخم، وزيادة الفقر، وتتسابق لوقف المزيد من التدهور في محفظتها المالية، وهو انخفاض يمكن أن يؤدي بسهولة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية ومطالب شعبية بالتغيير.
وأضاف التقرير أنه في الواقع، إذا لم يتم تنفيذ أي علاجات بالطريقة التي يواجه بها نظام السيسي الانهيار الاقتصادي القادم، فإن موجة الاحتجاجات عام 2011 التي أطاحت بالمستبد السابق حسني مبارك قد ينظر إليها على أنها معتدلة مقارنة بما هو ممكن بعد أكثر من 12 عاما.
وأوضح التقرير أن الانهيار المحتمل لمصر لن يكون محسوسا داخل حدودها فحسب، بل سيكون له تداعيات إقليمية ودولية أيضا. في الوقت الذي يشهد فيه السودان ما يمكن أن يصبح حربا أهلية طويلة الأمد يقودها ضابطان عسكريان غير خاضعين للمساءلة، وبينما تستمر ليبيا في البحث عن تسوية سياسية مستقرة لإنهاء انقساماتها، فإن الانفجار المصري لن يكون من السهل احتواؤه. كما أن الأمن على طول ساحل البحر الأحمر يمتد وصولا إلى مضيق باب المندب ويمتد إلى القرن الأفريقي. ولكن كما هو الحال مع الأمثلة الأخرى للانهيار الاقتصادي، لا يمكن تحسين الظروف الحالية لتأمين السلام الداخلي والاستقرار الإقليمي دون إصلاحات سياسية مصاحبة لمعالجة القمع الواسع النطاق والحكم الاستبدادي غير المقيد في البلاد.
الاقتصاد المزعزع للاستقرار
وأشار التقرير إلى أن المشاكل الاقتصادية في مصر ليست جديدة، وبالتأكيد لم تبدأ في العقد الماضي فقط في أعقاب انقلاب يوليو 2013 الذي قام به وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا للجمهورية، محمد مرسي. ومن المؤكد أنه بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن تضييق المجال السياسي، واجهت مصر تحديات اقتصادية منذ ثورة 1952، وكانت التحديات التي واجهت النيوليبرالية الزمرة لحكم مبارك الطويل في قلب ثورة يناير 2011. لكن خطورة الوضع الاقتصادي الحالي، وتسارع الانهيار المحتمل، والخيارات المحدودة بشكل متزايد في البلاد، قد تكون غير مسبوقة لدرجة أن أجراس الإنذار تدق بلا شك، ليس فقط في المؤسسات المصرية ولكن أيضا في العواصم الإقليمية والدولية الصديقة مثل الرياض وأبو ظبي وواشنطن.
ولفت التقرير إلى أن معدل الفقر في مصر يواصل اتجاهه التصاعدي السابق الذي يعود إلى زمن ما قبل ثورة 2011. ووفقا للأرقام الرسمية، يعيش 30 في المئة من المصريين تحت خط الفقر. لكن البنك الدولي يقدر أن 60 في المائة يجب اعتبارهم في الواقع فقراء أو ضعفاء. مع عدد سكان يزيد عن 108 ملايين نسمة، وتترجم هذه الأرقام إلى ما بين 30 و 60 مليون شخص فقير، وهي كتلة يجب أن يخشاها النظام الاستبدادي. ويتفاقم الفقر اليوم بسبب ارتفاع التضخم دون رادع والذي وصل إلى ما يقرب من 37 في المائة في يونيو الماضي (حوالي 65 في المائة للمواد الغذائية والمشروبات)، ارتفاعا من 34 في المائة في مايو.
ونوه التقرير بأن عجز الميزانية، والتحديات التي تواجه الواردات الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بسرعة (بنسبة 50 في المائة منذ بداية حرب أوكرانيا) يعد بتضخم أعلى في الأشهر المقبلة. ولا شك أن انسحاب روسيا الأخير من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع أوكرانيا للسماح بشحنات القمح من البلدين سيؤدي إلى تفاقم حالة الإمدادات الغذائية الشحيحة وما يصاحب ذلك من تضخم في أسعار السلع الأساسية لمصر، وكذلك بالنسبة للعديد من الدول الأخرى في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أرقام البطالة الرسمية التي تبلغ 7 في المائة (أكثر من 17 في المائة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) تعطي وقفة، خاصة خلال فترة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2023/2024 نحو 27 مليار دولار، مع ارتفاع الدين الوطني إلى أكثر من 165 مليار دولار، أي حوالي 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل خدمة الدين استنزافا كبيرا للموازنة (56 في المئة)، مما يحرم حكومة السيسي من القدرة على توسيع البرامج الاجتماعية للفقراء ومشاريع التنمية لمعالجة الأداء الاقتصادي الضعيف، وزيادة تكلفة الاقتراض. وعلاوة على ذلك، فإن 49 في المائة من الميزانية المذكورة تمول من الديون؛ وبعبارة أخرى، لولا الأموال المقترضة، لربما لم يكن لدى الحكومة ما يكفي للحفاظ على الخدمات الأساسية ودفع الرواتب.
كما أن اقتراض الأموال يزداد صعوبة. وتشير التقديرات إلى أن دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منحت نظام السيسي 100 مليار دولار منذ انقلاب السيسي في عام 2013، معظمها في شكل ودائع من البنك المركزي ووقود. وفي عام 2022 وحده، أعطوا السيسي 22 مليار دولار للتعامل مع المشاكل الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وغيرها من المخاوف. ولكن كما هو الحال مع جميع عمليات الاقتراض ، يأتي وقت لن تأتي فيه أي أموال دون أن تصاحب مطالب السداد أو التبادل. فعلى سبيل المثال، تبادلت صفقات بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعها في عام 2022 بين مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لمعالجة عجز الميزانية والاحتياطي الأجنبي لحصص الملكية الأجنبية في الشركات المملوكة للدولة في مصر.
وتابع التقرير:"بالنسبة لحصتها من الاستثمارات، حصلت الإمارات على أسهم في خمس من أكبر الشركات في مصر. من ناحية أخرى، واجهت تعهدات المملكة العربية السعودية وقطر بعض الصعوبات بسبب الاختلافات في تقييمات أصول الشركات الحكومية المصرية بعد التخفيضات المتكررة في قيمة العملة المصرية. والواقع أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان لم ينطق بأي كلمة عندما أخبر جمهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي أن المملكة لم تعد مهتمة بمنح المساعدات من أجل مصلحتها الخاصة، وأنها ستطالب منذ ذلك الحين بإصلاحات وعوائد على مساعداتها. كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن نفس الشعور".
وأردف:"بصفته مقرض الملاذ الأخير، وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لحكومة السيسي، يتم صرفه على مدى 46 شهرا، ومشروطا ببعض الإصلاحات الهيكلية التي ستواجه حكومة الانقلاب صعوبة في تنفيذها. في عام 2016، أقرض الصندوق حكومة السيسي 12 مليار دولار لوضع برنامج إصلاح اقتصادي لضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام. وفي كلتا الحالتين، قدم الصندوق صورة وردية للاقتصاد المصري والتزام الحكومة بالإصلاح. لكن محاولة الصندوق مساعدة خطط الحكومات المتعاقبة لإدخال ضبط النفس والعقلانية في السياسة الاقتصادية باءت بالفشل، وتحديدا بسبب ميل النظام إلى الإنفاق الباهظ على المشاريع الضخمة ودور الجيش في الاقتصاد، الذي يزاحم القطاع الخاص".
عظمة لا يمكن تحملها وجيش مهيمن
وأضاف التقرير أن أحد المشاريع التي تظهر الأولويات غير المتطابقة لنظام السيسي هو بناء عاصمة إدارية جديدة لتحل محل المباني الحكومية القديمة والمنتشرة في وسط القاهرة. وكان من المتوقع أن ينتهي المشروع، الذي أطلق في عام 2015، في غضون خمس سنوات وأن يكلف 58 مليار دولار، لكنه متأخر وتجاوز الميزانية بشكل خطير. وعلى الرغم من أن السيسي تعهد في وقت افتتاح المشروع الجديد بأن الحكومة لن تدفع مقابل أي منها، إلا أن الدراسات تظهر أن ما تم دفعه حتى الآن جاء من الصندوق العام للدولة، بما في ذلك الأراضي المكتسبة، والقروض المدعومة من الدولة، والدين الوطني المضاف. ويبدو أنه لم يكن هناك أي استثمار أجنبي مباشر لتمويل المشروع.
وأوضح التقرير أن من المشاريع الفخمة الأخرى التي لا داعي لها على ما يبدو توسيع قناة السويس في عام 2015، ما تبين أنه قناة موازية للقناة العادية التي تبلغ مساحتها حوالي ثلث حجمها فقط تكلف 8 مليارات دولار لبنائها ، دون فائدة اقتصادية كبيرة ، باستثناء 100 مليون دولار سنويا من الإيرادات الإضافية. ومع ذلك، فإن إحدى السمات المشتركة للمشروعين هي أنهما تم تنفيذهما مع إعطاء حصة كبيرة من العمل للشركات التابعة للجيش حيث يجد ضباط الجيش المتقاعدون والموالون للنظام وظائف ومزايا.
وأشار التقرير إلى أنه على مر السنين، وليس بالضرورة خلال حكم السيسي وحده، أصبحت المؤسسة العسكرية لاعبا اقتصاديا كبيرا ومهما في البلاد. في الواقع، الجيش المصري اليوم هو لاعب اقتصادي مستقل يسيطر عمليا على القطاع العام للدولة، وهو جوهر رأسمالية الدولة التي أسستها ثورة الضباط الأحرار عام 1952. وكتب يزيد صايغ أن الجيش يشارك أو يسيطر على "التطوير العقاري، وإنشاء مراكز الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، ورسملة القطاع العام بالاستثمار الخاص". وجميع الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العسكرية سرية، ولا يسمح لأي سلطة مراقبة خارجية بفحص سجلاتها. في الواقع، لا يزال أحد الاعتبارات المهمة في قرضي صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 هو الكشف العلني عن أعمال الجيش وتقليل دوره في الاقتصاد حتى يتمكن القطاع الخاص من التمتع بحرية تشغيلية جامحة.
لكن هذا الدور الاقتصادي يترافق مع توظيف واسع النطاق لآلاف الضباط العسكريين السابقين، ليس فقط في الشركات التي تسيطر عليها المؤسسات ولكن في القطاع العام على المستويين الوطني والمحلي. وهكذا، بالإضافة إلى الاقتصاد السري والمستقل، يمارس الجيش نفوذا سياسيا على النظام السياسي بأكمله، مما يحد من قدرة القطاع الخاص، أو في الواقع، الممولين الإقليميين والدوليين على فرض تغييرات على صورة الاقتصاد الكلي في مصر.
تغيير النظام الذي لا مفر منه
وأكد التقرير أنه بعد مرور واحد وسبعين عاما على تأسيس جمهورية مصر، هناك حاجة إلى إجراء تغيير جاد في الطريقة التي تحكم بها البلاد. لا يمكن لنظام السيسي الاستمرار في المسار الحالي لاقتراض الأموال لمعالجة عجز الميزانية أو تمويل البرامج الاجتماعية والتنموية والمشاريع الضخمة غير الحكيمة. ولا ينبغي للنظام أن يعتمد على فرضية خاطئة مفادها أن "مصر أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس" وأن يفترض أن المقرضين سيكونون دائما على استعداد لتوفير المبالغ الهائلة من القروض التي تحتاجها مصر. من المؤكد أنه مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وازدياد سوء الوضع الاقتصادي الكلي، ليس أمام النظام المصري سوى خيارين: زيادة القمع الذي من شأنه أن يستمر عقودا من الحكم الاستبدادي، أو الانتقال الديمقراطي التدريجي ولكن الملتزم الذي يمكن أن يعيد وعد ثورة 2011.
وقال التقرير إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن لاستمرار الحكم الاستبدادي الحالي أن يوفر الراحة اللازمة من عدم اليقين الاجتماعي والسياسي. لقد أعاقت عقود من الحكم الاستبدادي منذ ثورة 1952 التنمية السياسية والاقتصادية، ورسخت نخبة عسكرية ذات مصلحة ذاتية في جميع أنحاء النظام السياسي، وأفقرت عشرات الملايين من المصريين. منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حكم القمع والخوف المجتمع المصري. وقد أدت التنمية التي يشرف عليها الجيش ويتحكم فيها إلى تزايد الدين الوطني الذي يلتهم ببطء الأموال الأساسية للتنمية. سياسيا، أصبحت مصر تحت حكم الجيش جمهورية خوف يجرم فيها الرأي الحر، ويحتجز الآلاف من السجناء السياسيين إلى أجل غير مسمى، ويتبدد الوعد بمستقبل مشرق. بعبارة أخرى، إذا كان الاستبداد في قلب مشكلة مصر، فلماذا يعتبر الآن الدواء الشافي لإخراج البلاد من أزماتها التي طال أمدها؟
وشدد التقرير على أنه لا يوجد بديل لمصر سوى رسم مسار تدريجي نحو الانتقال السياسي من الحكم الاستبدادي. يمكن للحوار الوطني الجاري أن يوفر منصة جاهزة للتفاوض على فترة انتقالية بعيدا عن الحكم العسكري، شريطة أن يرفع النظام جميع القيود المفروضة على من يشارك فيه وما يتم مناقشته. ويقينا، لا يمكن للنظام ببساطة التفاوض مع نفسه أو مع القوى السياسية والمجتمعية الموالية التي وافقت منذ فترة طويلة على الوضع الحالي. وإلى جانب الحوار، ينبغي على النظام أن يبدأ عملية تخفيف الضغط السياسي التي تغرس روح القبول للنقاش والنقد وتفتح الباب أمام التغيير المؤسسي الأساسي، الذي حركت الرغبة فيه مطالب ثورة 2011.
واختتم التقرير:"يجب على السيسي وحلفائه ومؤيديه الإقليميين، وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن يدركوا أن تطبيق الحلول التجميلية مثل المساعدات والمنح دون إصلاحات اقتصادية وسياسية أساسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الانهيار السريع للنظام السياسي المصري. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، أن يسحب رأسه من الرمال ويرى أن التغيير في مصر فقط هو الذي سينقذ البلاد ويبقيها شريكا مستقرا وسلميا في منطقة مضطربة".
https://arabcenterdc.org/resource/egypt-is-in-serious-trouble-seven-decades-after-its-free-officers-revolution/